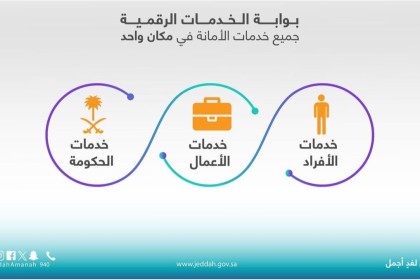الإسلام وخيار الديمقراطية.

تعلو بعض الأصوات في أوساط المجتمع العربي بين حينة وأخرى، تطالب بتطبيق الديمقراطية بالمفهوم الغربي، ولاسيما في أوساط الذين اغتربوا ردحًا من الزمن في الغرب ولمسوا الحرية اللادينية عن كثب، عما كانوا عليه في بلدانهم المحافظة. فمصطلح الديمقراطية مشتق من المصطلح الاغريقي "حكم الشعب" لنفسه، هو مصطلح قد تمت صياغته من شقين ( ديموس ) "الشعب" و( كراتوس ) "السلطة" أو "الحكم"، وأول ما اُستخدم هذا المصطلح كان في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في المدن اليونانية، ويقابله مصطلحًا آخر يُدعى أرستقراطيا ويعني "حكم نخبة أو فرد". يتناقض هذين النظامين منهجيًا من حيث الأيديولوجية، و يتقاربان من الناحية الدستورية التي أسست دعائمها الثورات الأوروبية بعد التخلص من استبداد وتسلط الكنائس الكهنوتية.
وإذا سبرنا غور منهج الديمقراطية من الناحية الدستورية يكون مقبولًا كمنهج سامي يحترم كينونة الفرد وإنسانيته، وإذا نظرنا إليه اجتماعيًا فإننا نجدهُ قد فُرغ من ضوابطه الأخلاقية. فواقع الحال الديمقراطية التي تتوافق مع شرع الله لا وجود لها على الأرض، وعندما تُفرض على الأمة الإسلامية تكون الديمقراطية هبة الإحتلال لهدم مبادئها. كما أن الديمقراطية القائلة بالمساواة بين البشر وبنسبية القيم لا ينتج عنها سوى ثقافة جماهيرية منحلة. فهي قوالب وأُسس وضعية قاصرة لا تغطي حتى أبسط احتياجات النفس البشرية.
ومن دواعي الأسى عندما نسمع نداءات بعض المفكرين المرموقين في محيطنا العربي يدعون لتبني أفكار مستوردة لا تتسق مع منهاج الرسالة المحمدية، يقترحون تصميم قالب جديد يشمل مبادىء الديمقراطية الوضعية، ويتم التنازل فيه عن بعض المبادىء الإسلامية، حتى تكون مقبولة لدى المجتمع بجميع طوائفه. فهذه هرتقات تقود الأمة إلى الانسلاخ عن معتقدها القويم. فالعقيدة لا تتجزء، وترك جزء منه يعتبر كُفر يُخرج من الملة وفق ما جاء في قوله سبحانه: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[آل عمران 85].
وإذا افترضنا جدلًا أن الديمقراطية المقولبة بأفكار غربية هي الحل الأنسب، فإننا بهذا نتخلى كُليةً عن ماورد إلينا من مورثات العدالة التي نرفه بها، وما وصلنا إليه من تقهقرٍ، لم ينجم إلّا عن محاولة استنساخ الأفكار الغربية التي فرضها الاستعمار الغربي من خلال قوالب الاغراء، وبطبيعة الحال هذا الوضع أدى إلى قصورنا في ترجمة الرسالة الإسلامية كما ينبغي، فكان لهذا دوراً سلبياً على الشعوب التي رضخت تحت وطأت الاحتلال لسنوات، حتى استولت عليهم أفكارها وغدت جزءًا من طبيعة حياتهم.
فمبادىء الإسلام لا تتنافى مع الديمقراطية النقية التي تحافظ على كرامة الفرد وتحميه من التجاذبات الفكرية الشاذة، فالمصطفى صلوات الله عليه قال : "إنما بعثت لإتمم مكارم الأخلاق"، فالدين الإسلامي أخذ الأفضل من كل ثقافات الأمم وقدمها في قالب موحد شامل، ولا مانع من الاستزادة والبحث وأخذ ما يثري مناهجنا علميًا بما لا يتعارض مع أساسيات الدين.
فالحضارات والثقافات هي نتاج بشر تراكمت عبر العصور نابعة عن فطرتهم التي أوجدها الله فيهم. وظهور مفهوم الديمقراطية وانتشارها السريع في بلاد الغرب، كانت بعد أن لُقحت حضارتهم بالحضارة الإسلامية أبان عيشهم تحت الحكم الإسلامي العادل، فنشأت مجموعات وفق ذلك اهتمت بالتحرر والتمرد على الفكر الكهنوتي للكنائس، دون الاعتبار لاشكاليات ضبط السلوك الاجتماعي المدني، وهنا يأتي التعارض الجوهري مع عقيدتنا التي تولي اهتمامًا بليغًا للنواحي الأخلاقية كمبدأ أساسي بعد عقيدة التوحيد.
فالدين الإسلامي اُرسل لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده أولًا، وإرساء قواعد الأخلاق وأدابه ثانيًا، وقد وردت كثيرٌ من الآيات القرآنية والأحاديث التي تظهر فيها أن العقيدة تتحدث في مجملها عن الأخلاق في المعاملات بصنوف أنواعه، فالأخلاق هي قاعدة بقاء أي أمة، كما قال الأديب أحمد شوقي :"
وَإِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ .. فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا" - و تَبنّي الديمقراطية من منطلق الفكر الغربي يُحدث تناقضًا خطيرًا في مجتماعتنا المحافظة، وقد تتكرر مأساة الغرب في انجراف الشعوب الإسلامية إلى مزالق الإلحاد. وإذا أردنا أن نطبق مفهوماً جديدًا للنهج الديمقراطي، فإنه لابد أن يصاغ مبادئه وفق الشريعة الإسلامية على منهاج رب العباد.
وعودةً إلى إرهاصات الديمقراطية التحررية أو الديمقراطية الليبرالية كما يحلو للبعض تسميتها، هي حقيقةٌ حركة اباحية تقود الأمة إلى نفق التعري، فهذه الحركة ما فتئت في كل محفلٍ إلا وتشكك في الأديان والعقائد التي تعمل على ترسية المبادىء الأخلاقية، بمن فيهم العقيدة الإسلامية التي واجهت هجمة شرسة بمختلف الأدوات التي لكم أن تتخيلوها، وهذا هو السبب الذي جعل منطقة الشرق الأوسط ملتهبة في محاولة بائسة لاجتثاث شأفة الإسلام منها، وقد يكون لهم أثرٌ بليغ إذا استمر عقلاؤنا في سباتهم السرمدي، وللأسف أن بوادر هذه الحركة ظهرت جليًا في أوساط مجتمعنا المحافظ، من خلال نتوءات سرطانية بشرية يدّعون بتحضر فكرهم الثقافي، وما هم للأسف إلّا أداة تُستهلك في نشر سموم أفكار الصهيونية الهدامة، ثم يتم الاستغناء عنهم ورميهم في مزابل التاريخ.
وإذا نظرنا إلى الحركة الليبرالية ورفضها لسطوة الأديان، لوجدناها طبيعية، فهي نشأت كردت فعل بسبب تسلط الكنائس على جميع شؤون الحياة الاجتماعية من خلال فرضيات محرفة تنافي فطرة النفس البشرية حتى ضاقوا بها ذرعًا، فلم يعد يفرقوا بين ما كانوا عليه وبين الأديان الآخرى، ومن الطبيعي أن يرفضوا أي دين حتى وإن حمل بين طياته الصواب. ولهذا بدأ المستشرقين الصهاينة الاندساس بين علماء المسلمين حتى غدا المجتمع لا يستطع أن يميزهم، فظهرت لنا بعض الأحاديث الوضعية والأقاويل الضالة الهادفة لجعل أمة محمد صلوات الله عليه تنحرف عن مسلكها القويم. ولا مخرج من هذه التراهات والتجاذبات الفكرية الدخيلة، غير العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية الأصيلة، وفق منهج سيد الخلق صلوات الله عليه، وتنقيتها من شوائب علماء الدرهم والدينار الذين استبدوا على معتقدات الشعوب.
بقلم : عثمان الأهدل
oalahdal@